بين انجيرلك وهمدان
جريدة الخليج تاريخ 20/8/2016
بصرف النظر عن الدافع العسكري الذي أطلق لتبرير تمركز قاذفات روسية في إحدى القواعد العسكرية في مدينة همدان الإيرانية لتوجيه ضربات ضد تنظيم داعش، ثمة أبعاد أخرى تقف وراء هذه الخطوة التي تعتبر بأقل المقاييس ، خطوة إستراتيجية لا تكتيكية متعلقة بسير معركة هنا أو هناك.
صحيح أن ثمة أكلاف تكتيكية أقل لانطلاق القاذفات الروسية من الأراضي الإيرانية باتجاه المناطق التي تسيطر عليها داعش ،مقارنة بالمسافة التي تنطلق منها القاذفات الروسية في الجنوب الروسي، إن لجهة الكلفة الزمنية التي لا تقل عن النصف، كما لجهة الأوزان المحمولة التي تساوي الضعف تقريبا، إلا أن القطبة المخفية في الموضوع تتعدى إطار الأكلاف إلى مسارات باتجاه تكوين شراكات إستراتيجية موازية لقواعد عسكرية أمريكية ، كالتي في تركيا وبالتحديد في انجيرلك. فهذه الأخيرة شكلت نقطة ارتكاز أمريكية في الشرق الأوسط ،لما لها من مواصفات إستراتيجية ،أن لجهة الاعتبارات الجيوعسكرية أو لجهة السلاح غير التقليدي المخزن فيها، وبالتالي ما تشكله هذه العوامل مجتمعة من أثر سلبي في العمق الحيوي الروسي.
وفي الواقع لعبت كل من تركيا وإيران دورا لامعا في الأحلاف السياسية والعسكرية التي ظهرت إبان الحرب الباردة كما بعدها، إلا أن مرحلة تشكل النظامين الإقليمي والدولي ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، كانت مناسبة هامة لكل من أنقرة وطهران للتفلت من بعض الضوابط التي سادت تلك المرحلتين ، لتشكلا مسارات خاصة هدفت إلى تكوين بيئات مستقلة للنفوذ ،وصلت إلى حد التنافس الحار على التركة السوفياتية السابقة في وسط آسيا وغيرها من المناطق التابعة سياسيا واقتصاديا وجيوسياسيا. ما أعطى هذين البلدين أوراق ضغط كثيرة ، استثمرت بشكل جيد من كلا الطرفين في تلك المرحلة الانتقالية لتكوين النظامين الإقليمي والدولي.
اليوم ثمة مصالح روسية إيرانية مشتركة، تبدأ بالعسكري والأمني ولا تنتهي بالاقتصادي والسياسي، ما أسهم في ترجمة الخيار الإيراني باتجاه إعطاء روسيا بمثابة القاعدة العسكرية بمبررات تبدو بالنسبة للغير منطقية، لكنها دونها عقبات إيرانية داخلية ، وبخاصة تجاوز نصوص دستورية كالمادة 146 التي لا تسمح بإعطاء قواعد عسكرية لأي دولة على الأراضي الإيرانية ، والتي بدأت بعض الأصوات ترتفع بهذا الخصوص ، بصرف النظر عن حجمها ونوعها والنهايات التي ستصل إليها.
في المقابل ، وان بدت قاعدة انجرليك كقاعدة أطلسية وبالتحديد أميركية مشروعا للمواجهة السياسية في أي محطة خلافية محتملة بين موسكو وواشنطن، إلا أنها تعتبر أيضا ارتكازا أميركيا لا يمكن التهاون في التعاطي معه ، لا ماضيا ولا مستقبلا، ودليل ذلك ما حدث بين موسكو وواشنطن في العام 1961 إبان أزمة الصواريخ الروسية في كوبا، وما تم مقايضته لإنهاء الأزمة آنذاك.
اليوم يبدو أن التنافس الروسي الأميركي على النفوذ سيتحول إذا ما استمرت الأمور على هذه الحال ، إلى نزاع ،ولا يستبعد أن يتطور إلى صراع ولو مستتر بالواسطة، بخاصة وان أدوات النزاع وحتى الصراع متوفرة ، إن كانت مثلا في أوكرانيا أو سوريا أو غيرها من المناطق، وبالتالي إن البحث عن تعزيز أدوات التنافس الصريح أو الصراع المستتر قائمة ومن بينها الاندفاعة الروسية باتجاه إيران.
لكن في النهاية ثمة سؤال يطرح في هذا المجال، مفاده حدود النجاح أو الفشل في هذا السياق، إن كان لموسكو في همدان أو لواشنطن في انجيرلك. بالعودة إلى التاريخ القديم كما الحديث، شكلت إيران هدفا قيصريا واضحا باتجاه التمدد الروسي نحو المياه الجنوبية الدافئة، واليوم تبدو الفرصة سانحة لموسكو أيضا في ظل ما يسمى الحرب الأمريكية الروسية الباردة، لكن في المقابل، ورغم حساسية العلاقات الأميركية التركية ، بخاصة بعد الانقلاب الأخير في تركيا ضد رجب طيب اردوغان، وموقف واشنطن الملتبس منه، من الصعب على أنقرة ممارسة الغنج السياسي المفرط على واشنطن، ما يعني أن ثمة عناصر إضافية لتأجيج التنافس والصراع بين موسكو وواشنطن إن كان في إيران أم في تركيا ، وبالتالي التعامل بنفس الوسائل والأدوات مع الأزمات المتصلة في المنطقة. ما يعني أن ثمة خاسرا واحدا هو شعوب المنطقة ومقدراتها، التي ظلت هدفا واضحا لهاتين الدولتين في شتى مراحل الصراع الدولي.

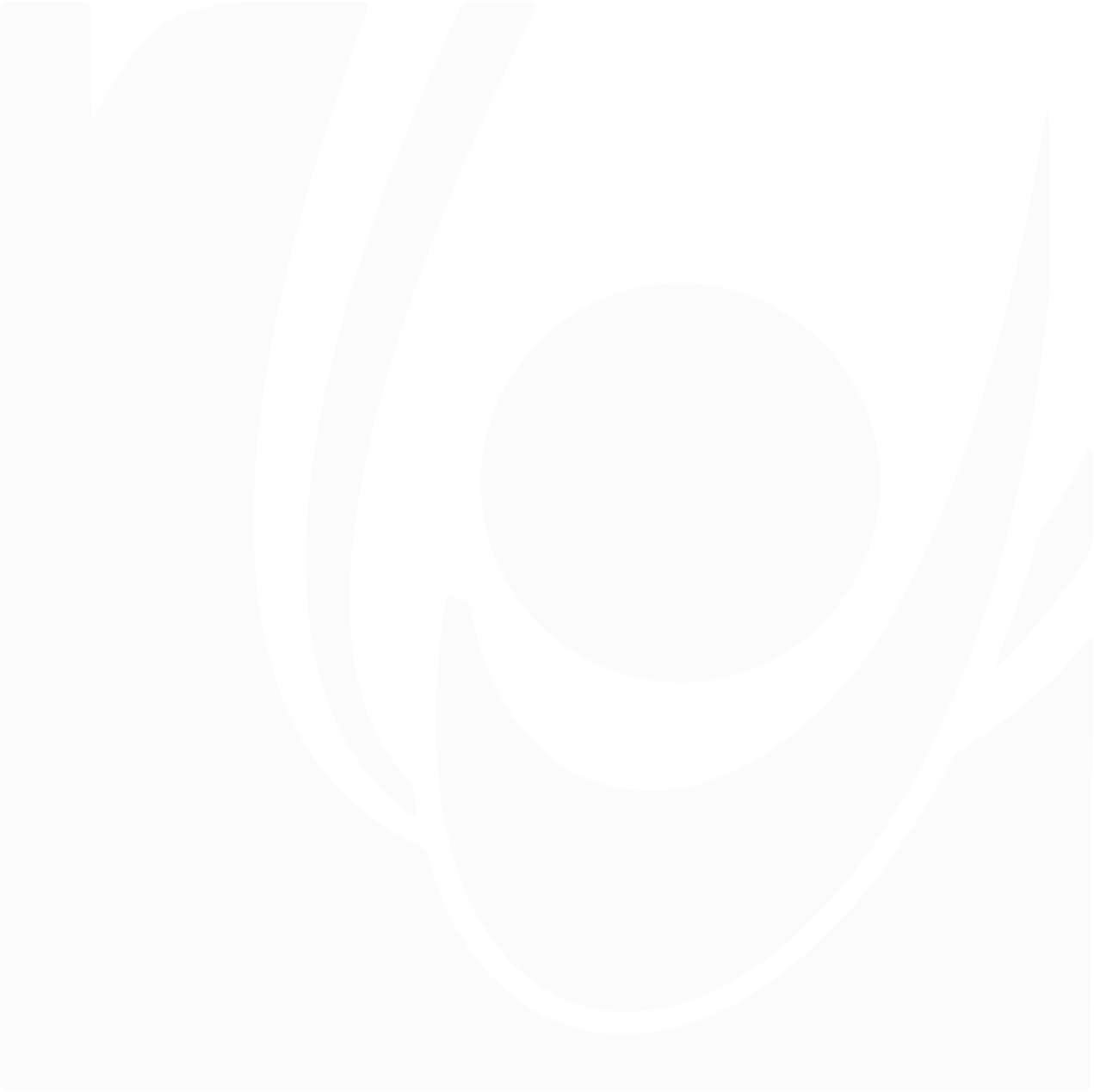
0 تعليقات:
ارسال التعليق